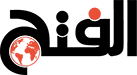من لوازم الإيمان بالنبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُرد التنازع إلى الكتاب الذي أرسله الله -جل جلاله- به، وإلى سنته -صلى الله
عليه وسلم-، كما أمرنا الله -جل جلاله- بذلك في محكم كتابه، فقال وهـو أصدق القائلين (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ).
وعن مجاهد في قوله: (فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) قال: "كتاب الله
وسنة نبيه -صلى الله
عليه وسلم-"، وقال ميمون ابن مهران: "الرد
إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله إن كان حيًّا، فإن قبضه الله إليه فالرد
إلى السنة"، وعن قتادة: "ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله"، وقوله تعالى:(ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)، قال أبو جعفر: "يعني بقوله جل ثناؤه: (ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) فرد ما تنازعتم فيه من شيء إلى الله والرسول خير لكم
عند الله في معادكم، وأصلح لكم في دنياكم؛ لأن ذلك يدعوكم إلى الألفة، وترك التنازع
والفرقة، وأحسن تأويلا يعني: وأحمد موئلا ومغبة وأجمل عاقبة". انتهى بتصرف.
وجاء في ((عمدة التفسير)): "وقوله:
(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ). قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله،
وهذا أمر من الله -جل جلاله- بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في
ذلك إلى الكتاب والسنة؛ كما قال تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ
إِلَى اللَّهِ)، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وشهدا له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؛ ولهذا قال تعالى:
(إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر)؛ أي: ردوا الخصومات والجهالات
إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنت تؤمنون بالله واليوم
والآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النـزاع إلى الكتاب والسنة، ولا يرجع إليهما
في ذلك فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر، وقوله: (ذَلِكَ خَيْر)؛ أي التحاكم إلى
كتاب الله وسنة رسوله والرجوع في فصل النـزاع إليهما خير، (وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)؛
أي: أحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير واحد".
يقول الشوكاني في ((فتح القدير)):
"المنازعة المجاذبة، والنـزع: الجذب كأن كل واحد ينتزع حجة الآخر ويجذبها، والمراد
الاختلاف والمجادلة، وظاهـر قوله: (فِي شَيْء) يتناول أمور الدين والدنيا، ولكنه لما
قال: (فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول) تبين به أن الشيء المتنازع فيه يختص بأمور
الدين دون أمور الدنيا، والرد إلى الله: هو الرد إلى كتابه العزيز، والرد إلى الرسول:
هو الرد إلى سنته المطهرة بعد موته، وأما في حياته فالرد إليه سؤاله، هذا معنى الرد
إليهما. وقيل: معنى الرد أن يقولوا: الله أعلم. وهو قول ساقط وتفسير بارد، وليس الرد
في هذه الآية إلا الرد المذكور في قوله تعالى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى
أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم، قوله:
(إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر) فيه دليل على أن هذا الرد
متحتم على المتنازعيـن وإنه شأن من يؤمن بالله واليوم الآخـر، والإشارة بقـوله: (ذَلِكَ)
إلى الرد المأمور به (خَيْر) لكم (وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)؛ أي: مرجعا من الأول آل يؤول
إلى كذا؛ أي: صار إليه. والمعنى: أن ذلك الرد خير لكم وأحسن مرجعًا ترجعون إليه، ويجوز
أن يكون المعنى أن الرد أحسن تأويلا من تأويلكم الذي صرتم إليه عند التنازع".
يقول ابن القيم: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ) نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله،
جليه وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه، ولم يكن كافيا
لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النـزاع إلى من لا يوجد
عنده فصل النـزاع.
ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله
-جل جلاله- هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته.
ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان
ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولاسيما
التلازم بين هذين الأمرين، فإنه من الطرفين، وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر، ثم أخبرهم
أن هذا الرد خير لهم، وأن عاقبته أحسن عاقبة، ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى
غير ما جاء به الرسول فقد حكَّم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد
حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو
يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون
أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم
انسلخ من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم
إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- إلى الطاغوت ومتابعته،
وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم، ولا قصدوا
قصدهم، بل خالفوهم في الطريق والقصد معًا، ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل لهم:
(تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُول). أعرضوا عن ذلك ولم يستجيبوا
للداعي، ورضوا بحكم غيره، ثم توعدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم
وأبدانهم وأموالهم بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم غيره والتحاكم إليه كما قال
تعالى: (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ
ذُنُوبِهِم) اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق؛ أي بفعل ما يرضي الفريقين
ويوفق بينهما كما يفعله من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول وبين ما خالفه، ويزعم
بذلك أنه محسن قاصد الإصلاح والتوفيق، والإيمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء
به الرسول وبين كل ما خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي، فمحض الإيمان في هذا
الحرب لا في التوفيق وبالله التوفيق".
فالواجب إذا ما دبَّ الخلاف ووقع النـزاع
أن يُرد ذلك إلى كتاب الله وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإذا ما ظهر الحقُّ بأدلته لزم المؤمن
الانصياع والإذعان، قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)، يقول العلامة ابن كثير
رحمه الله بعدما ذكر سبب نـزول الآية وذكر من ذلك قصة زينب بنت جحش وزواجها وقبولها
للزواج من زيد بن حارثة، وكذا قصة الفتاة التي تزوجت جليبيبا استجابة لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله
بشيء فليس لأحدٍ مخالفته، ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأي ولا قول، كما قال تبارك وتعالى:
(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ)، ولهذا شدد في خلاف ذلك، فقال:
(وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)؛ كقوله تعالى:
(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ): "أي عن أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وسبيله ومنهاجه وطريقته وسنته، وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله
وأعماله، فما وافق ذلك قُبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان".
فإن العاصمَ من قاصمة الخلاف التزام سنة
النبي -صلى الله
عليه وسلم-؛ كما في حديث: عن الْعِرْبَاض بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ
اللَّهِ -صلى الله
عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا
فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا
الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ!
فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ
وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى
اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ
الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ
وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»،
قال العلامة ابن رجب رحمه الله: "هذا إخبار منه -صلى الله عليه وسلم- بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه، وفي الأعمال
والأقوال والاعتقادات، وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة،
وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي ما كان عليه -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، ولذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته
وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، والسنة: هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان
عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة"،
ولقد كان سلف الأمة أحرص الناس على متابعة ما كان عليه رسولهم -صلى الله عليه وسلم-، والتزام ما دلت الأدلة على أنه الحق، ولو خالف هذا من خالف، فإنهم متفقون
اتفاقا يقينيًّا على وجوب اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله
ويترك إلا رسول الله -صلى الله
عليه وسلم-؛ ولذلك كان أحدهم إذا جاءه حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولو على خلاف ما هو عليه قبله وطرح ما كان عليه، ولله در الإمام الشافعي
إذ يقول: "أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكن له أن يدعها لقول أحد".
ولقد وعى صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- وتابعوهم -صلى الله
عليه وسلم- كلام الله وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فحرصوا أشد الحرص على لزوم الكتاب والسنة والتأدب معهما، وتقديمهما على
أقوال سائر البشر، فـ "عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ
زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: كَتَبَ إِلَيَّ
رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله
عليه وسلم- أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ
مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. فَرَجَعَ عُمَرُ".
فهذه آيات القرآن وأحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وعبارات أهل العلم، كلها قاطعة في وجوب رد التنازع إلى الكتاب والسنة،
واتباع الحق الذي تدل الأدلة عليه، فليتنا اليوم ونحن نهب لنصرة نبينا -صلى الله عليه وسلم- نعظم كلام ربنا وكلام نبينا -صلى الله عليه وسلم-، ونرد خلافاتنا إلى الله ورسوله، فإذا ما ظهر لنا الحق اتبعناه، ولو خالف
ذلك قول أي أحد من البشر كائنا من كان، فهل من المحبة للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن نتعصب لأقوال متبوعين، ونرد كلام الله -صلى الله عليه وسلم- وكلام رسوله -صلى الله
عليه وسلم-؟!
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله:
"والذي ندين لله به ولا يسعنا غيره أن الحديث إذا صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يصح عنه حديث آخر بنسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه،
وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان"، "فالقلب الصحيح
السليم: ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه، فهو صحيح الإدراك للحق
تام الانقياد والقبول له. والقلب الميت القاسي: لا يقبله ولا ينقاد له. والقلب المريض:
إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي، وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم".
فالحصن الحصين لنا من كل كيد هو التمسك
بالكتاب والسنة، يقول الشنقيطي رحمه الله في ((أضواء البيان)): "ولو كان المسلمون
يتعلمون كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله
عليه وسلم-، ويعملون بما فيهما لكان ذلك حصنًا منيعًا من تأثير الغزو الفكري في عقائدهم
ودينهم، ولكن لما تركوا الوحي ونبذوه وراء ظهورهم، واستبدلوا به أقوال الرجال لم تقم
لهم أقوال الرجال ومذاهب الأئمة رحمهم الله مقام كلام الله والاعتصام بالقرآن، وكلام
النبي -صلى الله
عليه وسلم-، والتحصن بسنته؛ ولذلك وجد الغزو الفكري طريقا إلى قلوب الناشئة من المسلمين،
ولو كان سلاحهم المضاد القرآن والسنة لم يجد إليهم سبيلا، ولا شكَّ أن كل منصفٍ يعلم
أن كلام الناس ولو بلغوا ما بلغوا من العلم والفضل لا يمكن أن يقوم مقام كلام الله
وكلام رسوله -صلى الله
عليه وسلم-، وبالجملة فمما لا شك فيه أن هذا الغزو الذي قضى على كيان المسلمين ووحدتهم،
وفصلهم عن دينهم لو صادفهم وهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله لرجع مدحورًا في غاية
الفشل؛ لوضوح أدلة الكتاب والسنة".
فيا إخوة الإسلام آن الأوان أن نطرح التعصب
جانبًا، وأن نستجيب للحق من كتاب الله وسنة -صلى الله عليه وسلم- رسوله -صلى الله
عليه وسلم-، ففي ذلك نجاتنا ونجاة أمتنا، وهذا هو الطريق لوحدتنا، وأعظم البرهان
على صدق حبنا، فمن جاءه النص من كتاب الله -صلى الله عليه وسلم- وسنة نبيه -صلى الله
عليه وسلم- فأعرض عنه تعصبًا لشيخ أو جماعة فهو كاذب
في دعواه محبة النبي -صلى الله
عليه وسلم-، ونصرته له، وقد ذكر بعض الباحثين أن الوصول إلى الحق فيما تنازع الناس
فيه يمر بخمسة مراحل:
أولها: التنازع، وذلك كأن يحدث تنازع في
مسألة ما، فيرى بعضهم الوجوب ويرى آخرون الاستحباب، أو يرى فريق التحريم وآخر الكراهة...
وهكذا.
ثانيها: رد التنازع إلى الكتاب والسنة عملا
بقول ربنا: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا).
ثالثها: استخراج النص فيما تنازع الناس
فيه.
رابعها: فهم النص بفهم الصحابة رضوان الله
عليهم؛ لأنهم الذين أخذوا الدين غضًّا طريا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
خامسها: تطبيقه كما طبقوه.
ولو فعلنا ذلك لضاق الخلاف وانحصرت دائرته،
وهذا هو الواجب علينا اليوم حتى تتحد كلمتنا، ويلتئم جرحنا، ونرد كيد الأعداء في نحورهم،
فهل من مجيب؟ والله المستعان.
وانظر معي إلى الإمام الشافعي رحمه الله
وهو يقول في باب الصيد من كتاب ((الأم)): "كل شيء خالف أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سقط، ولا يكون معه رأي ولا قياس، فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول
الله -صلى الله
عليه وسلم-، فليس لأحد معه أمر ولا نهي غير ما أمر هو به".
وقال أيضا: "رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به". وقال الإمام محمد الكوفي
-صلى الله
عليه وسلم-: "رأيت الإمام الشافعي بمكة وهو يفتي
الناس، ورأيت الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه حاضرين، فقال الشافعي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وهل ترك لنا عقيل من دار» فقال إسحاق: روينا عن الحسن وإبراهيم أنهما
لم يكونا يريانه، وكذلك عطاء ومجاهد. فقال الشافعي لإسحاق: لو كان غيركم موضعك لفركت
أذنه، أقول قال رسول الله -صلى الله
عليه وسلم- وتقول: قال عطاء ومجاهد والحسن! وهل لأحد
مع قول الرسول -صلى الله
عليه وسلم- حجة؟!" اهـ.