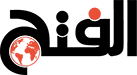لم تكن مفاجأة ما أسفرت عنه عملية الاستفتاء على الدستور الذى جاء نتاج لتوافق سياسى ومجتمعى باستثناء فصيل واحد ظل رافضًا للعملية السياسية منذ يونيو 2013، متمسكًا بشعار "الشرعية" رغم ما يحمله هذا الشعار من خداع سياسى لا يستقيم وواقع الحال الذى عاشته مصر ما قبل الثلاثين من يونيو.
فكما هو معلوم أن شرعية أي نظام حاكم لا تُستمد من نجاحه فى الانتخابات فحسب، بل تظل هذه الشرعية مرهونة بإرادة الناخبين الذين أوصلوه إلى الحكم، فإذا ما تغيرت هذه الإرادة أو تبدلت سقطت شرعية ذلك النظام.
وفى هذا الخصوص يميز الباحثون بين الشرعية المُكتسبة من الرضا الشعبى والمشروعية المبنية على أسس صحة المسار القانونى المُتبع فى الوصول إلى الحكم. وما بين الشرعية والمشروعية من مساحة كبيرة تظل تتراوح بين العمل السياسى متمثلاً فى الإرادة الشعبية وبين النص القانونى متمثلاً فى نصوص الدستور والتشريعات القائمة.
وإذا كان الحديث عن الشرعية قد سقط بمجرد خروج الملايين إلى الشارع فى الثلاثين من يونيو ورفضهم للنظام القائم آنذاك، فإن المشروعية قد تلاشت مع نتيجة الاستفتاء على تعديلات الدستور المُكسب للمشروعية في مرحلة ما قبل الثلاثين من يونيو.
فقد أكدت نتيجة الاستفتاء على أن المطالب والشعارات المرفوعة من جماعة الإخوان ومؤيدوها لم تعد لديها أية شرعية سياسية ولا مشروعية قانونية، وهو ما يعنى أن الدولة فى مرحلتها الراهنة ما بعد الاستفتاء مسئولة عن استكمال تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق بدءًا من الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة. تلك مقدمة رأيت أهمية ذكرها لتوضيح كثير من اللبس لدى البعض فى خلطه بين الشرعية والمشروعية وكيفية اكتسابهما وفقدانهما.
إلا أن الحديث الأكثر أهمية فى تلك اللحظة الراهنة هو إقحام الإيمان والكفر فى هذا الصراع السياسى، فصحيح أن طبيعة الدين الإسلامى أنه منظم لشئون الحياة كافة، بما يعنى الرفض المطلق لأية دعوات تتحدث عن فصل الدين عن الدولة بأية درجة من الدرجات، إلا أنه من الصحيح أيضًا أن استدعاء الدين ورفعه كشعار فى خصومة سياسية أمر مرفوض كلية، خاصة إذا كانت الخصومة تتعلق بتنظيم مسار الحياة السياسية دون التطرق إلى المبادئ والأحكام الكلية المنظمة لتلك الحياة. بمعنى أكثر وضوحًا إن استدعاء قضية الكفر والإيمان فى صراع سياسى لا يعنى سوى أمرين:
الأول، أن أحد الطرفين ظن انه قد حاز العلم كله وان رايه صواب لايحتمل الخطأ وان مخالفه رايه خطا لا يحتمل الصواب . ومن ثم، فإن أقواله وتفسيراته لا مرد لها، كونه يحتكر الحقيقة المطلقة فى عالم اليوم، وما عداه كفر وزندقة وهرطقة. أما الأمر.
الثانى، يتمثل فى أن محاربة هذا
الطرف الذى يرى فى نفسه أنه يحتكر العلم كله ، لا يعنى سوى محاربة الدين فى عمومه
وأحكامه، حيث يحدث الخلط بين الدين وبين هذه الجماعة أو الفرد.
وترتيبا على ذلك، يُترجم هذا الخطاب إلى واقع عملى يصبح
فيه العنف والعنف المضاد سيدي الموقف، وتصبح عمليات القتل ذات مشروعية، حيث تستند
فتوى هدر الدم إلى شرعية إلهية، ومن يقوم بتنفيذ هذه المهمة إنما يؤدي واجبًا
دينيًا يُحتسب له في الآخرة. وهذا كله بسبب أحادية النظرة واحتكارية الفهم
وإطلاقية الرؤية، وهو ما نهى عنه الدين الإسلامى الحنيف حينما جعل الاختلاف سنة
إلهية وحكمة كونية وفطرة إنسانية مصداقًا لقوله تعالى:"ولو شاء ربك لجعل
الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفون".
ولذا، حينما يعتقد البعض أنه يملك الحقيقة المطلقة وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنما تجاوز - بهذا الاعتقاد- الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية ومقاصدها الحقيقية، وذلك من خلال ما يطرحه من فتاوى مضللة واجتهادات خاطئة وهو ما حذر منه النبى محمد عليه الصلاة والسلام فى الحديث النبوى الذى رواه ابن حبان في صحيحه عن حذيفة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتي رئيت بهجته عليه, وكان ردئًا للإسلام, غيره إلي ما شاء الله, فانسلخ منه, ونبذه وراء ظهره, وسعي علي جاره بالسيف, ورماه بالشرك,.
قال: قلت: يا نبي الله.. أيهما أولي بالشرك؟ المرمي أم
الرامي؟ قال: بل الرامي", فهذا الرجل الموصوف في الحديث قرأ القرآن حتي ظهرت
بهجة القرآن عليه, لكنه لم يكتف بالقراءة, بل انتقل إلي الاستنباط والإفتاء, دون
معرفة بالقواعد الكلية والأحكام الفقهية، فظن فى نفسه العلم والمعرفة وصار يُصدر
الأحكام دون ضوابط أو قواعد منظمة كما درج عليها علماء الأمة وفقهاءها.
خلاصة القول إن لجوء كل طرف فى الصراع السياسى أو الاجتماعى لاستدعاء الخطاب باسم الدين لإضفاء مشروعية على أفعاله، يمثل نذير خطر على مستقبل العيش المشترك، حيث يتجذر منطق العنف أكثر فأكثر، وتغيب الحكمة والسماحة وقبول الآخر واحترام الرأى المخالف دون تسفيه أو تحقير، وهو ما يهدد الوطن فى مجموعه، والدولة فى كيانها، والمجتمع فى لحمته وتماسكه، وهو ما يلقى بحمل المسئولية على المؤسسات الدينية وفى مقدمتها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لتصحيح هذه المفاهيم والرد على تلك الشبهات، ولهذا حديث آخر.